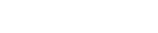خاص هيئة علماء فلسطين
د. أحمد الفراك[1]
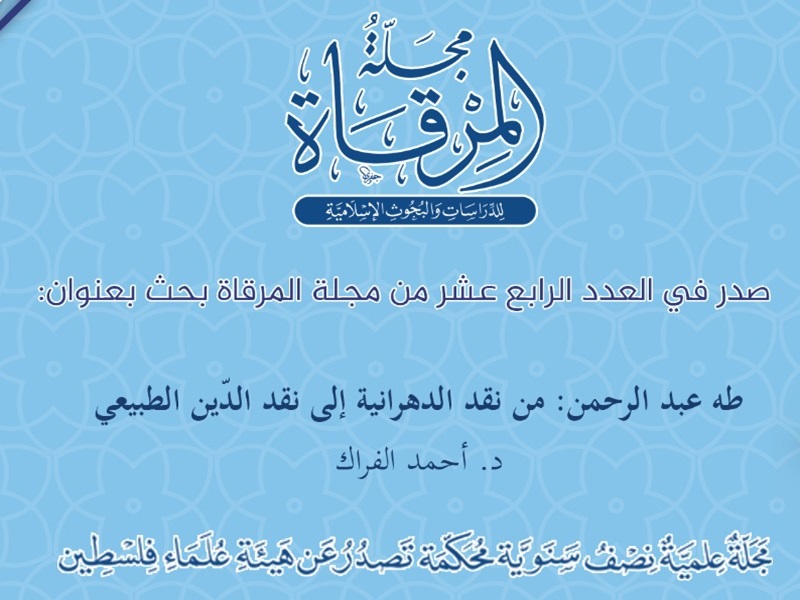
ملخص
لا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، من بين ما يتميز به، اشتغاله في واجهتين؛ واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر، ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. فضلاً عن أن تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين ومن الحضور النقدي في صلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السّجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يُظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية.
كلمات مفاتيح: العقلانية- الدهرانية- الدين الطبيعي- دين الفطرة- الائتمانية.
Summary
It is no secret that what distinguishes the intellectual project of the philosopher Taha Abdel Rahman is that it works in two aspects: The interface of the Arab Islamic heritage and the extensions of its fields، schools، and sects in the present، and the methods of studying and evaluating it، and the interface of the Western heritage and its various extensions within and outside contemporary Western culture. In addition to his positioning at the heart of Arab Islamic culture، this did not prevent him from seriously engaging in the core concerns of contemporary philosophers and from being critically present at the heart of contemporary philosophical problems، and even engaging controversially with the most famous philosophers and moralists on major philosophical، scientific، and ethical issues، in a way that shows his use of the same mechanisms، approaches، and methods that They use it to produce their philosophical knowledge.
Keywords: Rationalism – Secularism – Natural Religion – The Religion of Instinct – Honesty.
مقدمة
اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وعينه على واقع الأمة الإسلامية والإنسانية، فأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة، أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا، وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، وظلّ مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم.
يُتفق مع مواقف الرجل ويُختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الَّدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة، تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها.
وإذا كانت الفلسفة بنتُ عصرها كما يقولون فإن طه فيلسوفٌ ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، ومن زمانه راجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا، ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ، ويمكن نعت طه بأنه فيلسوفٌ إسلامي عربي معاصر أصيل خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، حيث تلقَّفها تلقُّف العارف النَّاقد واستثمر تلقُّفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حدٍّ سواء.
وقد خصَّص الفيلسوف عبد الرحمن طه كتابه “بؤس الدهرانية” لتجلية النقد الائتماني لأطروحات فصل الأخلاق عن الدين، في صيغها الأربع؛ النموذج الطبيعي، والنموذج النقدي، والنموذج الاجتماعي، والنموذج الناسوتي، وقد انطلقت هذه الصيغ الأربع من نقد آفة الخرافية: أي نقد اللاعقلانية التي لحقت الدين المسيحي وأفسدت روحانيته، ونقد آفة الحمية: أي نقد تعصب المذاهب العقدية المسيحية وخلوها من قيمة السماحة، مما تسبب في نشوب فتنٍ مُدمرة وحروبٍ طاحنة وتمزقاتٍ اجتماعية أتت على الأخضر واليابس، ويمكن تقديم النموذج الطبيعي بمرجعيته المتمثلة في العقلانية الأنوارية، مثالا للنقد الذي وجَّهه طه عبد الرحمن للدهرانية.
ولا يخرج النقد الائتماني في هذه الحالة عن النقد العقلاني للعقلانية الدهرانية التي فصلت بين الدّين والأخلاق، دون إعلانها معاداة الدّين بالضرورة[2]، فالفلسفة الائتمانية هي فلسفة عقلانية[3]، إن لم تكن مذهبا من أوسع مذاهبها، لأنها في الوقت الذي تنبني فيه الفلسفة الدهرانية على نموذج “العقلانية المجردة” تتأسس هي على مقابلها نموذج “العقلانية العملية”، فيكون عقل الفلسفة المجردة –في نظر طه- أدنى من عقل الفلسفة العملية الذي هو “عقل أعلى”[4]، حيث “العقل الأعلى يستوعب كل الإمكانات العقلية للعقل الأدنى-استشكالات واستدلالات- ويزيد عليها من الإمكانات ما ليس في طاقته وما يدفع آفاته؛ فالعقل المسدَّد يحتوي العقل المجرَّد، صارفا مفاسده؛ والعقل المؤيَّد يحتوي العقل المسدَّد، مجتنبا عوائقه”[5].
المبحث الأول: بؤس العقلانية والصيغة الطبيعية للأنموذج الدهراني
معلوم أن “الفيلسوف لا يضع فلسفته من أجل خويصة نفسه، فهو يجتهد في أن يكشف للناس الحقائق والأباطيل التي خَفيت عليهم، تبصرة لهم وتوعية، ويرشدهم أيضا إلى الخيرات وضرورة إتيانها، ويحذرهم من الشرور وضرورة اجتنابها”[6]، ولذلك فطه يجعل من واجبه إصلاح ما أفسده المفسدون من أفكار وأوضاع، وعدم الاكتفاء بمعرفة الحق من الباطل في ذاته، بل النهوض ببيان الحق وأفضاله حتى يتبعه الناس وفضح الباطل وأضراره حتى يجتنبه الناس. ولما انتشرت بين الباحثين أطروحات تدعي لنفسها اختيارا دينيا بلا دين، وأخلاقا بلا أخلاق، حاول أن يتصدى لها من خلال نقد أصولها ومضامينها.
ففي نقده لنماذج “الدين الطبيعي” بوصفه دينا دُنيانيا، ينتقد طه ما يسميه بـ”بؤس العقلانية”[7]، ويقصد به كل تفكير يقتصر على التوسل بالعقل المجرد، ويقوم على “فصل الأخلاق عن الدين ينزع عن الأخلاق لباسها الروحي ويكسوها لباسا زمنيا”[8]، ويتخذ من الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو خير ممثل للصيغة الطبيعية لـ”الفصل الدهراني” بين الدين ونفسه [9].
المطلب الأول: دين الطبيعة والعقل المجرد
دين الطبيعة هو دينٌ بلا وحي، يتضمن اعتقادات وأخلاق تصدر عن العقل والضمير، وقد عرَّفه أندريه لالاند بكونه “مجموعة اعتقادات بوجود الله ورحمته، وبروحانية النفس وخلودها، وبالطابع الإلزامي للعمل الأخلاقي، بوصفها كلها من وحي الوعي و”النور الداخلي” الذي ينور كل إنسان”[10]، كما ورد في المعجم الفلسفي لجميل صليبا بأن “الفرق بين هذا الدين الطبيعي والدين الوضعي أن الأول قائم على وحي الضمير والعقل، على حين الثاني قائم على وحي إلهي يقبله الإنسان من الأنبياء والرسل”[11]، مما يفيد بأن الدين الطبيعي هو دين العقل مستقلا عن الوحي[12]، لا يعترف لا بإله ولا بنبي ولا بكتاب مُنزَل، ومن القائلين به من فلاسفة عصر الأنوار: دافيد هيوم[13](ت1776م)، وجون جاك روسو(ت1778م)، وجون تولاند[14] (ت1722م)، ودنيس ديدرو[15] (ت1784م)، وأنتوني كولينز[16] (ت1729م)، ومن المعاصرين نذكر جورج سانتيانا[17](ت1952م).
رغم أن روسو قد نشأ نشأة دينية، وتربى على الأخلاق والتقوى[18]، إلا أنه يميز بين الِّدين الطبيعي بوصفه “دين خصوصي” يتعلق بضمير الفرد ومعتقده، والدِّين المُنزَل، بوصفه “دين عمومي” للجميع، ودعا -في رسالته- إلى عدم تصديق الأفكار المتوارثة سواء أكانت عقلية أو نقلية، أي فلسفية أو دينية، مُعدّاً ذلك أنه داخل المتن الفلسفي تنشأ وتتطور وتنتشر الكثير من الأفكار الخاطئة، حيث يقول بهذا الصدد: “أدركتُ أن الفلاسفة لم ينفوا عني الرَّيب بقدر ما يزيدونه قوة وإيذاء… فأعرضتُ عنهم وأقبلت على دليل آخر. قلت: لأستشر الوجدان، إذ لا يمكن أن يُضلني أكثر مما يفعلون، إن أخطأت فعلى الأقل سيكون الخطأ مني، والضّرر سيكون أخفّ إن اتّبعت أوهامي أنا بدل أن أنصاع إلى تمويهاتهم”[19].
فضلاً عن تخوفه من التشكيك والقلق وزعزعة اليقين الذي تسرب إلى نفسه جراء رفقته لبعض الفلاسفة المعاصرين له، سواء أكانوا ملاحدة أو عقائديين متغطرسين، والذين لكِبْرهم وعجزهم[20] يفضلون الجدل والشهرة على طلب الحقيقة وقول الحق، ومع ذلك لا يجدون حُججا عقلية مقنعة ترد أباطيلهم وسفسطاتهم، باستثناء حجج القلب[21]، كما يجب –في نظره- التوقف عن تصديق جميع الأفكار التي يتناقلها رجال الدين، وتحكيم الضمير الفردي في كل المعارف دينية كانت أو فلسفية، لأن جميع الأفكار “لا تُقنع على الفور”[22].
وفي توضيح موقف روسو يرى عبد الله العروي أن الطريق السليم إلى دين الفطرة الرُّوسوي هو نفسه طريق الفطرة الإنسانية الأصيلة والبريئة، وإن كان المرجع في هذا الدين ليس هو الوحي المنزل من السماء وإنما هو ضمير الفرد، وليس طريقه النبوة، وإنما طريقه العقل الحر، أي “حكم ضميره، نور وجدانه”[23]، وقد سبق للعروي أن أقر بأن “الموقف الفطري للإنسان هو موقف الطبيعيين”[24]. فهل دين الطبيعة هو دين الوحي؟ وهل العقل الحر هو العقل المجرد؟ وهل يصح أن يُسمى ديناً بلا ديانة ولا كتاب؟
من قراءة النص (دين الفطرة) يتبين في نظر العروي أن روسو يُصرح بأنه يريد أن يصنع “عقيدة بسيطة، بيّنة، صادقة، توفق بين العقل والوجدان، وتضمن للفرد الطمأنينة وللمجتمع الوحدة والاستقرار”[25]، وهو بهذا يُعلن رفضه لجميع العقائد، بما فيها العقائد المنزلة، حيث يقول “بما أننا نرفض الخضوع لأية سلطة بشرية، لا نصادق على أية عقيدة متوارثة في بلد مولدنا، كل ما يمكن أن يهدينا إليه نور العقل في حدود الطبيعة هو دين الفطرة”[26].
فالمصدر هو نور العقل في حدود الطبيعة، ولا نور فوق نور العقل ولا غيب وراء الطبيعة، ولا ندري أين وجد العروي قُرب عقيدة “دين الفطرة إلى عقيدة الإسلام؟ وهل تلخيصه لمقولات روسو في العبارات التالية: “الإيمان في خدمة النفس، الدين في خدمة المجتمع، المجتمع في خدمة الفرد”[27]، يفيد انسجام دين الفطرة مع دين القرآن؟ وهل يستلزم ذلك بأن العروي يدعو المسلمين من عقائدهم إلى عقيدة روسو؟ وهل يصح قول البعض بأن موقف العروي منسجم مع ذاته في الدعوة إلى أن التحديث في جميع الحقول يأتي من الغرب بما فيه التحديث الديني؟ وأنه لا إصلاح إلا في إطار ما يقترحه الغرب؟
المطلب ثاني: النقد الائتماني لعقلانية الصيغة الطبيعية للدين الطبيعي
على خلاف العقلانية المجردة بمبادئها الكلاسيكية الثلاثة (الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع)، ووعيا منه بمضامين قراءة عبد الله العروي لـ”دين الفطرة”، يذكر طه عبد الرحمن بأن العقلانية الائتمانية تستند إلى ثلاثة مبادئ تصبغها بصبغة الإسلامية الخالصة، وهي: الشهادة والأمانة والتزكية، ومن خلالها سيُقوِّم مضامين مُسمّى الدين الطبيعي.
-مبدأ الشهادة: ويقضي بإقرار الإنسان بوحدانية الله وإشهاد الله على ذلك، وشهادة غيره له بذلك، وبهذه الغيرية يفضُل مبدأُ الشهادة على مبدأَ الهوية التي تنبني عليه الفلسفة غير الائتمانية.
-مبدأ الأمانة: ويقضي بتحمل الإنسان مسؤولياته: مسؤولياته عن نفسه وعن غيره من الكائنات والأشياء بوصفها أمانات لديه، وبهذه المسؤولية يفوق مبدأُ الأمانة مبدأَ عدم التناقض الذي تقوم عليه العقلانية غير الائتمانية، إذ يتحمل العقل الائتماني المسؤولية في حفظ الاتساق العقلي، وبذلك تَسمَّى بـ”العقل المسؤول”[28].
-مبدأ التزكية: ويقوم على أن التزكية هي الطريق الوحيد للتحقُّق بالقيم الخلقية والمعاني الروحية، ودرء الآفات السلوكية والاختلالات الأخلاقية المانعة من طلب الكمال والترقي في الإنسانية، إذ “الأصل في التزكية هو الترقية”[29] فردية وجماعية، ويقرر عبد الرحمن أكثر من هذا فيرى أن “التزكية هي أقدر من غيرها على التصدي للعلل الاجتماعية، بل للآفات العالمية، خُلقية كانت أو روحية”[30].
وبهذه المبادئ الثلاثة للعقلانية الائتمانية تستمد الفلسفة الائتمانية “عقلانية التأييد” من المرجعية المؤسِّسة للتراث الإسلامي، وهي تشتمل على ثلاث فلسفات؛ “فلسفة الشهادة” و”فلسفة الأمانة” و”فلسفة التزكية”، وجُماع ذلك هو ما به تستحق أن تُسمى: “فلسفة إسلامية حقيقية” أو “فلسفة إسلامية خالصة”. والسؤال الذي يطرح لأول وهلة هو: هل تنحصر إمكانات التفلسف المستند إلى المرجعية الإسلامية في الأمانة والشهادة والتزكية؟ وهل نضرب صفحا عن مجالات الخوض الفلسفي كما تتعاطاه الأمم الأخرى؟ أم يتعلق الأمر بفلسفة متعالية ونبيلة، لا تصلح للتعميم ولا للعموم؟
ندع الجواب ونعود إلى طه عبدالرحمن، فهو يرى أن صاحب دين الفطرة لا يحترم المبادئ الثلاثة السابقة، بل يُدلس على القارئ في رسالته “عقيدة قسيس سافوا”، لأن ما يدعو إليه ليس هو الدين القائم على الوحي المنزل على الأنبياء وما يتضمنه من شرائع وشعائر وأحكام وأخلاق، وإنما هو “الدين الطبيعي” أو دين الضمير الذي لا يطيع إلا أوامر الطبيعة[31]، حيث الطريق إلى دين الفطرة لا تحتاج إلى وسيط، ولا إلى رسالة، ما دامت تتأسس على التوفيق بين العقل والوجدان، وترتكز على الصدق والبساطة والوضوح، لذلك “من الخطأ أن نتوهم أن الدين الطبيعي يطابق الصورة الفطرية للدين المنزل، فنجعل منه “دين الفطرة”[32] للأسباب الآتية:
1-إنّ روسو وإن كان يُقر بوجود الرّب الخالق فهو لا يقر بمبدأ الشهادة كما تقدم، فهو يضرب صفحا عن الوحي والنبوة، بل ينكر الوحي والملائكة والنبوة[33]، إذ هو مع الحاجة إلى المعرفة يشهر استغناءه عمَّا يهديه[34] (وحي أو نبي). وإن اعترف بأن “وراء حركة الكون ونشاط الطبيعة توجد إرادة”[35]، واعتقد بأن هذه الإرادة عبارة عن “كائن فاعل عاقل”[36] أو “عقل أسمى”[37] هو “الكائن المريد القادر”[38].
2-ارتباط مفهوم الفطرة بمفهوم الخَلق الأصلي للإنسان، وروسو لا يؤمن إلا بالانسجام مع النظام الكوني للطبيعة، وإن تحدث عن الخالق والصانع. ثم هو لا يعتبر حقيقة بديهية إلا ما اطمأن إليها قلبه، وما دون ذلك لا يهتم به[39]، فمن يضمن لنا أن قلب روسو هو معيار الحقيقة؟
3-ارتباط مفهوم الفطرة بأصل الخِلقة، في مقابل التباس مفهوم الطبيعة وتعدد دلالاته (الغريزة، قانون الطبيعة، الجوهر، الطبيعة الكونية)، فضلاً عن أن الطبيعة في نظر روسو هي التي تريد للإنسان كيف يكون[40].
4- إذا كانت الروح هي القوة الإدراكية المقترنة بالفطرة، فيمكن تسمية الدين الفطري بـ”الدين الروحي”، لكن القوة الإدراكية المقترنة بالطبيعة هي العقل، فيكون الدين الطبيعي هو “الدين العقلي” أو “دين العقل”، الذي حرص الفلاسفة الدهرانيون على إخراج صيغه العقلية، وإن اتخذ هذا الإخراج صيغا متعددة، أحصى منها طه ثلاث صيغ، وهي: “الإخراج التجريدي” و”الإخراج التسديدي” و”الإخراج التأييدي”[41].
واضح إذن أن “دين الفطرة” هو في حقيقته “دين الطبيعة” أو “دين العقل”، والذي لا يمكنه أن يعوض دين الوحي أو ينوب عنه، ولعل ذلك ما يقصده كانط في نقده للاهوت الطبيعي، حيث يقول: “مهما بلغ الأمر باللاهوت الطبيعي، إلا أنه لن يستطيع أن يبوح لنا بشيء حول غاية نهائية للخليقة، كونه لا يصل حتى إلى حدود طرح السؤال حولها”[42]. وشتان بين دين الروح الذي يستند إلى القيم والمعاني ويؤسس الظاهر على الباطن، ودين العقل الذي يتأسس على الظاهر والمجرد ويُحجَب عن القيم والمعاني. هذا على الرغم من أن روسو يصرح بأنه يجمع بين الوجدان القلبي والبرهان العقلي، لكن ذلك لا يجيز التعبير بالترادف بين دين الطبيعة ودين الفطرة.
من جهة أخرى يذهب روسو إلى قَرْن الدين الطبيعي بأخلاق الباطن، ذلك أن ضمير الإنسان –وليس عقله-هو الذي يرشده إلى القانون الإلهي الأخلاقي الذي يسكن في القلب، دون أن يخطئ في إرشاده، مُعِدّا أن الإيمان هو أساس الفضائل كلها، غير أن هذا الإيمان الرُّوسوي، وإن سماه “المذهب الرباني” لا يتوقف على وحي ولا نبوة، بل هو “تغذية للقلب من مادته”[43] فكيف يجتمع الإيمان مع عدم الإيمان بالملائكة والكُتب والرُّسل؟ أليس “شكه في الوحي هو في حكم إنكاره”[44] يقول طه؟
أما الدين العمومي في نظر روسو فقد أنتجته المؤسسات البشرية التي غطَّت الواجبات الأخلاقية الباطنة بواجبات أخلاقية ظاهرة، وهو ما يشبه الصورة الوقتية للدين المنزل، إلا أنه إذا كان الأمر في نظر روسو يوجب التسليم بالدين العمومي، فإنه في نظر طه يجب عدم التسليم بالصورة الوقتية للدين المنزل، بل يجب تجديدها عبر إرجاعها لموافقة الصورة الأصلية، فضلاً عن أن الصيغة الطبيعية للأنموذج الدَّهراني التي تنكر الوحي والرسالة، لا تسلم ولا تعمل بالشرائع المنزلة، إلا أن تكون ثناء باللسان وعملا بالقلب، ومعلوم أن من ينكر الآمرية الإلهية والعمل بالشعائر ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ناهيك عن كون العمل بالشعائر هو الذي يورث المؤمن كمال التخلُّق[45]، ومن يُغيِّب الآمرية الإلهية يقع في الآمرية الآدمية التي تجعل الإنسان مُشرعا لنفسه، وكأن ضميره إلها يأمره وينهاه ويحكم على أفعاله وأفعال غيره. ولهذا نجد روسو أحيانا يشبه مشاعره بصفات الإله[46].
المبحث الثاني: بؤس العقلانية والصيغة النَّاسوتية للأنموذج الدهراني
في إطار نقده للنماذج الدهرانية اتخذ طه عبد الرحمن فلسفة لوك فيري نموذجا للصيغة الناسُوتية (Humanisme)، والناسوتية هي الصيغة التي اختارها بدلا من صيغ أخرى مشتهرة مثل الإنسية والإنسانوية، وقد علّل هذا الاختيار بمقصد “إبراز التقابل الموجود بين “الناسوت” و”اللاهوت””[47].
يُعرف على لوك فيري أنه ينتقد المذاهب الفلسفية المعاصرة ويعيب عليها ميلها إلى التعقيد، كما أنه يعد من دُعاة مناهضة الإنسية المعاصرة، ويشتهر عنه أيضا أنه من فلاسفة البحث عن الخلاص، ومن أشهر كتبه “الإنسان الإله أو معنى الحياة”، و”تعلم الحياة”، و”مفارقات السعادة”، و”أجمل قصة في تاريخ الفلسفة”. ولعل أهم سؤال يحاول أن يجيب عنه في مؤلفاته هو: كيف نعيش حياة طيبة بالعقل؟ وكيف نُحقق الطمأنينة والخلاص خارج الدين؟
المطلب الأول: لوك فيري والصيغة الناسوتية للأنموذج الدهراني
يرى الفيلسوف الفرنسي لوك فيري أن الفلسفات الكبرى هي بمثابة “عقائد خلاص” عقلاني لاديني، أي خلاص من غير إله ولا وحي ولا نبوة، وهدف الفلسفة في نظره هو التعويل على العقل في إيجاد أجوبة لأسئلتنا المقلقة ومنها الأسئلة الوجودية من قبيل معنى الحياة والموت والمصير، مع التعالي وعدم الإذعان لأجوبة الإيمان، لأن إخضاع العقل للإيمان يجعل الفلسفة خادمة للدين[48]، وفي هذا الوضع المنقلب “لابد للعقل أن ينحني في النهاية أمام حقائق الوحي. وأما الفلسفة فهي تشاطر الدين الغاية الرامية إلى تحديد شروط حياة طيبة بالنسبة إلى البشر الفانين. ولكنها على العكس من ذلك، تريد بلوغ تلك الغاية من خلال استقلالية العقل وحدة الوعي، بالوسائل المتاحة وحدها-إن صح القول- وبفضل القدرات وحدها التي يمتلكها الكائن البشري بنفسه”[49].
في إطار التعالي العلماني أو “الروحانية اللائيكية”[50] التي تبحث عن المعنى والطمأنينة في العقل “دون المرور بالإله، ولا بالإيمان”[51]، يقابل لوك بين عقيدة الخلاص الدينية والأفكار الفلسفية عن الخلاص[52]، معتبرا أن المسيحية “ديَّنت” المفاهيم الفلسفية العقلانية واستخدمتها في الدفاع عن الإيمان المسيحي، ونقلت مفهوم العقل الرواقي الذي يفيد معاني الانسجام مع الكون إلى مفهوم العقل الخادم للمسيح[53]، من أجل “عقيدة خلاص مُغفل وأعمى”[54]، وأنه قد آن الأوان، لتخليص أفكار الخلاص الفلسفية من عقيدة الدين الإلهي وإرجاعها إلى الإنسان، أي أنسنتها بمصالحتها مع العقل، ومن صميمها “أنسنة الأجوبة عن مسألة الحياة الطيبة”[55].
كل ما يُنسبُ إلى الإله في الدِّين المنزل، ينسُبه المذهب الناسوتي إلى الإنسان في دين العقل، أي إلى العقل الآدمي، مع العلم أن كلمة “الإلهي” عند فيري لا تشير بالضرورة إلى إله مفارق خالق ورازق، وإنما تعني مفهوم الإلهية عند اليونان، “إذ ما كانوا يسمونه بالإلهي (thion) هو، بكل بساطة، الكوسموس، النظام السرمدي للكون، الذي كانت النظرية الفلسفية تأملا فيه.
فالآلهة اليونانية، وخاصة منها آلهة الجيل الأول، ليست على وجه الدقة أشخاصا، فهي قلما تكون مفردة لأنها أولا وقبل كل شيء قطع من الكوسموس، وقوّى في الكون: جايا هي الأرض، وأورانوس هي السماء، وبنتوس السيول، وبوسيدون البحار، وتارتار باطن الأرض… “[56]، ولهذا يصرح في غير ما موضع من كتبه بضرورة فصل القيم عن الدين وإلحاقها بالفلسفة لاكتساب استقلالها، مما يجعلها مفاهيم علمانية يستخدمها حتى الملحدون[57]، وقد بلغ الأمر بفيري إلى استعارة مفهوم “الإنسان الإله”[58] من الدين المسيحي للدلالة على استبدال آمرية الإله بآمرية العقل لنفسه، رغم علمه بأن الإنسان عاجز عن إيجاد جواب برهاني، فبالأحرى إقناع نفسه بجواب عن طريق البرهان، حيث يقول: “لأننا ندرك بوضوح ما يجعلنا تعساء، ولكن يصعب علينا تحديد معرفة ما يسعدنا بالدّرجة نفسها من الوضوح”[59].
وبخصوص مُسلمة التخلُّق المزدوج، يميز لوك فيري بين أخلاق الواجب (Morale) وأخلاق الخلاص (Ethique)، وتتعلق الأولى بالأوامر والنواهي التي ترتكز على ما لحقوق الغير على الذات وإرادة الخير للآخرين، بينما تتعلق الثانية بمصير الإنسان ومعاناته وتخوفه من المرض والألم والموت والتناهي الإنساني، مهما تيسرت له سبل الحياة ومُتعها. مع أن الأصل في أخلاق الواجب والخلاص عند فيري هو “التعالي المقارِن” للذات الذي يستطيع الإنسان اكتشافه من داخل تجربته الفردية، دون ما حاجة إلى جهة خارجية تمده به، أي من غير اعتماد على وحي من إله أو إلهام من سماء، وهذا التعالي ليس سابقا عن الأخلاق وإنما هو موازٍ لها، وبطريقة لا تقبل البرهان، واعتماد الإنسان على عقله فقط في اكتشاف هذا التعالي الأفقي يفيد مما يفيده أن الإنسان يوحي إلى نفسه بنفسه، ويصنع مصبؤس العقلانية ونقد النماذج الدهرانية: (روسو ولوك فيري)
خصص طه عبد الرحمن كتابه بؤس الدهرانية لتجلية النقد الائتماني لأطروحات فصل الأخلاق عن الدين، في صيغها الأربع؛ النموذج الطبيعي، والنموذج النقدي، والنموذج الاجتماعي، والنموذج الناسوتي، وقد انطلقت هذه الصيغ الأربع من نقد آفة الخرافية: أي نقد اللاعقلانية التي لحقت بالدين المسيحي وأفسدت روحانيته، ونقد آفة الحمية: أي نقد تعصب المذاهب العقدية المسيحية وعدم تسامحها، مما تسبب في نشوب فتنٍ مدمرة وحروبٍ طاحنة وتمزقاتٍ اجتماعية أتت على الأخضر واليابس كما يقال.
وقد اخترت الاكتفاء بنموذجين طالهما هذا النقد وهما: النموذج الطبيعي بمرجعيته المتمثلة في العقلانية الأنوارية، والنموذج الناسوتي بمرجعيته المتمثلة في العقلانية اليونانية.
والنقد الائتماني هنا هو نقد عقلاني للعقلانية الدهرانية التي فصلت بين الدين والأخلاق، دون إعلانها معاداة الدين بالضرورة[60]، فالفلسفة الائتمانية هي فلسفة عقلانية[61]، إن لم تكن مذهبا من أوسع مذاهبها، لأنها في الوقت الذي تنبني فيه الفلسفة الدهرانية على العقلانية المجردة تتأسس هي على العقلانية العملية، فيكون عقل الفلسفة المجردة – في نظر طه- أسفل وأدنى من عقل الفلسفة العملية الذي هو عقل أعلى[62]، حيث “العقل الأعلى يستوعب كل الإمكانات العقلية للعقل الأدنى-استشكالات واستدلالات- ويزيد عليها من الإمكانات ما ليس في طاقته وما يدفع آفاته؛ فالعقل المسدد يحتوي العقل المجرد، صارفا مفاسده؛ والعقل المؤيد يحتوي العقل المسدد، مجتنبا عوائقه”[63]، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الإعلاء من شأن العقل المؤيد جاء على نقيض الإعلاء من شأن البرهان عند ابن رشد والرُّشديين.
المطلب الثاني: بؤس العقلانية والصيغة الطبيعية للأنموذج الدهراني
في نقده لنماذج “الدين الطبيعي” بوصفه دينا دُنيانيا، ينتقد طه عبد الرحمن ما يسميه بـ”بؤس العقلانية”[64]، وهو كل تفكير في نظره يقتصر على التوسل بالعقل المجرد، ويقوم على “فصل الأخلاق عن الدين ينزع عن الأخلاق لباسها الروحي ويكسوها لباسا زمنيا”[65]، ويتخذ من الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ممثلا للصيغة الطبيعية لـ”الفصل الدهراني” بين الدين ونفسه. [66]
وقد أفصح روسو عن مضامين هذه الصيغة الدهرانية في الجزء الرابع من كتابه المشتهر “إيميل” أو “في التربية” تحت عنوان “عقيدة قسّيس سافُوَا”، أو “دين الفطرة” الذي كتبه سنة 1762م، وهي السَّنة نفسها التي صدر فيها كتابه المشتهر “العقد الاجتماعي”، وفيه قرر أن هناك تضاداً بين دين الطبيعة ودين الوحي، أو بين “الدّين الطبيعي” و”الدّين الـمُنزل”، وأقام موقفه على ثلاثة شكوك، وهي: “إنكار الوحي”، و”إنكار الملائكة”، و”إنكار النبوة”، وقد توقع لهذا الكتاب أن “يثير ثورة يوما ما بين الناس، إذا قُدر للإدراك السليم ولحسن النية أن يولدا من جديد”[67].
ولعل هذا الموقف من الدين هو ما دفع عبد الرحمن طه إلى التعبير عنه بــ”عقدة الدين”، في خاتمة كتابه “ثغور المرابطة”، وعقدة الدين أو العقدة الروحية يقصد بها تقليد أغلب أساتذة الفلسفة العرب للمتفلسفة من الغرب في معاداة الدِّين، فكما يعادي أولئك دينهم يعادي هؤلاء دينهم، دون مراعاة الفروق بين الدينين والواقعين والتدينين، إذ “ما أسرعهم إلى تقليد المفكرين العلمانيين في مسألة “عدم الإيمان”[68]، لذلك تجدهم يعادون الدين إطلاقا وتقليدا، بل ينقلون أدلة الغربيين عن إنكار دينهم نفسها، ظانين أن إمَّعيتهم في نقل إلحاد غيرهم سيصيب قراء مكتوبهم بالإلحاد أيضا كما أصابهم هم، فقلدوا العلمانيين مرتين: مرة في إنكار الدين أو لادينية الدين، ومرة في الانحياز لدين العلمانية، أو قل دين اللادين، ولهذا كان “أحد القيود المانعة من انطلاق العقل هو التقليدُ، والنقلُ عن الفلاسفة أسوأ تقليد يعرفه الفكر العربي”[69]، حتى أنكروا وجود الإيمان في الفلسفة، بل أنكروا اجتماع الإيمان مع العقل، على خلاف ما يقره طه بقوله: “من يتحقق بحب الإيمان ينفتح له من أبواب الحرية وآفاق الإبداع ما لا ينفتح لسواه”[70].
الخاتمة
نخلص من خلال هذا المقال إلى أن أطروحة الدين الطبيعي بمسمياتها المختلفة كانت محط سجال نقدي من طرف كثير من الفلاسفة المعاصرين، ومنهم طه عبد الرحمن، من خلال نقده لاستدلالات فلاسفة دافعوا عن معقولية دين بلا وحي، أو دين من غير إله ولا معتقدات، حيث كشف الخلفية الفلسفية للقول الدهراني بصيغتيه الطبيعية والناسوتية.
ففي كتابه “بؤس الدهرانية” الذي اتخذناه مصدرا لهذا النقد حاول طه تجلية مراجعته النقدية لأطروحات فصل الدين عن الأخلاق، في أضربها الأربعة؛ الضرب الطبيعي، والضرب النقدي، والضرب الاجتماعي، والضرب الناسوتي. كما استنتج أن القول بدين الفطرة عند روسو يحمل تدليسا في استدلالاته في رسالة “عقيدة قسيس سافوا”، لأنه يسميه دينا وشريعة وعقيدة وهو في الحقيقة لا علاقة له بالدين اعتقادا وتشريعا وأخلاقا إلا من جهة الاسم، فكيف يكون للدين الطبيعي أو دين الضمير الذي لا يطيع إلا أوامر الطبيعة أم يماثل دين الوحي المنزل على الأنبياء والمرسلين؟، كما أن خلو دين الفطرة أو دين العقل من رُسل وسيطة ومن كتب منزلة، يخرجه من دائرة الدين الحق ويلحقه بتخمينات الفلاسفة وظنونهم ولاهوتهم المصطنع.
المصادر والمراجع
- أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، ترجمة هليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط 2، 2001م
- إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 2005م.
- جان جاك روسو، دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافوا. ترجمة عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2012م
- جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، ترجمة بولس غانم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2015م
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1، 1972م
- جيل غاستون غرانجي، العقل، ترجمة محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2004م
- سعيد علي عبيد، فلسفة القيم عند جورج سانتيانا، نيوبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2017م
- طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014م
- طه عبد الرحمن، شرود ما بعد الدهرانية: النقد الائتماني للخروج من الأخلاق، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط1، 2016م
- طه، عبد الرحمن. العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2، 1997م.
- طه، عبد الرحمن. ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية، منشورات مركز مغارب، الرباط، ط 2، 2019م
- طه، عبد الرحمن. روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس حداثة إسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2006م.
- طه، عبد الرحمن. رُوح الدِّين: من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، 2012م.
- طه، عبد الرحمن. سؤال السيرة الفلسفية: بحث في حقيقة التفلسف الائتمانية، مركز نهوض للدراسات والبحوث، بيروت، ط1، 2023م
- عبد الله العروي، السنة والإصلاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 2، 2010م.
- لوك فيري، الإنسان المؤله أو في معنى الحياة، ترجمة محمد هشام، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط. 1، 2002م
- لوك فيري، تعلم الحياة، ترجمة سعيد الولي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، ط1، 2011م
- لوك فيري، مفارقات السعادة: سبع طرائق تجعلك سعيدا، ترجمة أيمن عبد الهادي، دار التنوير، بيروت، ط1، 2018م
- لوك فيري، وكلود كبلياي، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود بن جماعة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2015م
- Jacqueline Lagre، la religion naturelle، Paris، PUF، coll. “philosophies”، 1991
- Luc Ferry، Lhomme Dieu ou le sens de la vie، Editions Grasset & Fasquelle، Paris، 1996
- Weber، Max. Le savant et le politique، trad. j. freund، collection10/18، Paris، 1996.
- Arendt، Hannah، Condition de lhomme moderne، Editions Clamann-Lvy، Paris، 1983.
- Touraine، Alain، Critique de la modernit، dition fayard، 1992.
************
لتحميل العدد 14 أو أي بحث ضمنه:
——————–
لقراءة جميع الأعداد مع تفاصيل الأبحاث ضمنها:
——————-
لتحميل جميع الأعداد المنشورة من (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة pdf:
[1] أستاذ الفلسفة بجامعة عبد المالك السعدي- تطوان، ورئيس فريق البحث في الفكر الكلامي والفلسفي بالمغرب والأندلس، تاريخ استلام البحث، 15/4/2024م، وتاريخ قبوله للنشر، 27/5/2024م، البريد الالكتروني: a. elfarrek@uae. ac. ma
[2] ويقصد في هذا المقام فلاسفة الأنوار مثل بارون هولباخوديدرو وفولتير، انظر: بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 33
[3] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2014م، بيروت، ص 13
[4] فكرة تقسيم العقل إلى عقل أدنى وعقل أعلى كانت متداولة في الفكر اليوناني الكلاسيكي وما بعد الكلاسيكي، انظر: جيل غاستون غرانجي، العقل، مرجع سابق، ص 15
[5] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 13
[6] المرجع نفسه، ص 56
[7] المرجع نفسه، ص 23
[8] المرجع نفسه، ص 13
[9] المرجع نفسه، ص 35
[10] أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، ترجمة هليل أحمد خليل، منشورات عويدات، ط 2، 2001م، بيروت، 3/1204
[11] جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ط 1، 1972م، بيروت، 1/573
[12] Jacqueline Lagre، la religion naturelle، Paris: PUF، coll. “philosophies”، 1991، p 9
[13] في كتابه: “محاورات في الدين الطبيعي” (Dialogues Concerning Natural Religion) .
[14] في كتابه: “المسيحية ليست غامضة” (Christianity Not Mysterious).
[15] في كتابه: “في كفاية الدين الطبيعي” (De la suffisance de la religion naturelle).
[16] في كتابه: “خطاب في أسس وأسباب الدين المسيحي” (A Discourse of the Grounds and Reasons of the Christian Religion).
[17] انظر: سعيد علي عبيد، فلسفة القيم عند جورج سانتيانا، نيوبوك للنشر والتوزيع، ط 1، 2017م، القاهرة، ص 206
[18] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، مرجع سابق، ص 48
[19] جان جاك روسو، دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافوا. ترجمة عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، ط1، 2012م، الدار البيضاء، ص 30
[20] المرجع نفسه، ص 28
[21] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، مرجع سابق، ص 51-52
[22] جان جاك روسو، دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافوا، مرجع سابق، ص 30
[23] المرجع نفسه، ص 17
[24] عبد الله العروي، السنة والإصلاح، مرجع سابق، ص 36
[25] جان جاك روسو، دين الفطرة، ص 9
[26] المرجع نفسه، ص 17
[27] المرجع نفسه، ص15-16
[28] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 16
[29] المرجع نفسه، ص 16-17
[30] المرجع نفسه، ص 18
[31] المرجع نفسه، ص 24
[32] المرجع نفسه، ص 36
[33] المرجع نفسه، ص 36
[34] المرجع نفسه، ص 50
[35] المرجع نفسه، ص 40
[36] المرجع نفسه، ص 43
[37] المرجع نفسه، ص 44
[38] المرجع نفسه، ص 48
[39] المرجع نفسه، ص 31
[40] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، مرجع سابق، ص 31
[41] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 117
[42] إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، مرجع سابق، ص 400
[43] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، مرجع سابق، ص 32
[44] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 50
[45] المرجع نفسه، ص 58
[46] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، مرجع سابق، ص 25
[47] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 46
[48] لوك فيري، تعلم الحياة، ترجمة سعيد الولي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط 1، 2011م، أبو ظبي، ص 93-106
[49] لوك فيري، وكلود كبلياي، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود بن جماعة، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1، 2015، بيروت، ص 17
[50] المرجع نفسه، ص 18-19، وانظر أيضا: لوك فيري، الإنسان المؤله أو في معنى الحياة، ترجمة محمد هشام، دار إفريقيا الشرق، ط 1، 2002م، الدار البيضاء، ص 199
[51] المرجع نفسه، ص 20
[52] فيري، لوك. تعلم الحياة، مرجع سابق، ص 100
[53] المرجع نفسه، ص 101
[54] المرجع نفسه، ص 101
[55] فيري، لوك. وكلود كبلياي،. أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص 35-38
[56] المرجع نفسه، ص 36
[57] انظر: فيري، لوك. تعلم الحياة، مرجع سابق، ص 99
[58]Luc Ferry، L’homme Dieu ou le sens de la vie، Editions Grasset &Fasquelle، 1996، Paris، p 173
[59] لوك فيري، مفارقات السعادة: سبع طرائق تجعلك سعيدا، ترجمة أيمن عبد الهادي، دار التنوير، ط1، 2018، بيروت، ص 8
[60] ويقصد في هذا المقام فلاسفة الأنوار مثل بارون هولباخوديدرو وفولتير، انظر: بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 33
[61] طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 13
[62] فكرة تقسيم العقل إلى عقل أدنى وعقل أعلى كانت متداولة في الفكر اليوناني الكلاسيكي وما بعد الكلاسيكي، انظر: غرانجي، جيل غاستون. العقل، مرجع سابق، ص 15
[63] طه، عبد الرحمن. بؤس الدهرانية، مرجع سابق، ص 13
[64] المرجع نفسه، ص 23
[65] المرجع نفسه، ص 13
[66] المرجع نفسه، ص 35
[67] جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، ترجمة بولس غانم، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، 2015م، بيروت، ص55
[68] طه، عبد الرحمن. ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية، منشورات مركز مغارب، الرباط، ط 2، 2019، ص 241
[69] المرجع نفسه، ص 236
[70] المرجع نفسه، ص 235